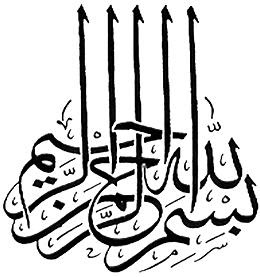
لا
أريد أن أتحدّث اليوم عن الإسلام بشكل عام، ولا عن الإسلام وما جلبه
للحضارة العالمية، وإنما أريد أن أتحدث عن إمكانية انتشار الإسلام في
العالم الغربي في أيامنا هذه.
تمهـيد
عندما نشأت الدعوة إلى الإسلام، كان العالم حينئذٍ غارقاً في شتى ألوان
الفوضى والانحطاط العام، فالامبراطوريات الكبرى، من بيزنطية وفارسية
وإمبراطورية القبط ومملكة الويز يغوط، كانت في دور التفكك والانهيار.
ولما جاء الإسلام ونزلت آيات القرآن، معلنةً أن الخلق والأمر بيد الله
سبحانه وتعالى، عاد لملايين البشر ثقتهم بإنسانيتهم ذات المصدر الإلهي،
واتجهوا إلى صياغة حياتهم الاجتماعية صياغةً جديدة.
وهنا يمكن أن يطرح علينا سؤال: أليس الإسلام قد قدّم للإنسانية فكرة السلطة
العلوية، كما قدم فكرة الجماعة والعمل لصالح المجتمع، في عالم تناسوا فيه
القوى الإلهية، وفي مجتمع يتجه بكليته إلى طريق الفردية، ما جعل الوضع يبدو
غير قابل للاستمرار، وجعل الثورات على الطريقة الغربية مستحيلة؟
نتائج الحضارة الغربية
إننا بعد خمسة قرون من سيادة الغرب سيادة تامة ـ بدون منازع ـ يمكن تلخيص نتائج حضارته فيما يلي:
1 ـ على الصعيد الاجتماعي: لقد صرف للتسلّح على سطح هذه الكرة الأرضية عام
1982م مبلغ 650 مليار دولار، ولو وزع هذا المبلغ على أفراد البشرية لأصاب
الفرد الواحد أربعة أطنان من المتفجرات، وفي نفس تلك السنة، توفي في العالم
الثالث خمسون مليوناً بسبب الجوع أو سوء التغذية.
ومن الصعب أن نسمي خط سير الحضارة الغربية، وتوصلها إلى إمكانية تدمير
الحياة على سطح الأرض وإنهاء ثلاثة ملايين سنة من تاريخ البشر، لا يمكن أن
نسمي ذلك بحال من الأحوال تقدماً.
2 ـ أما على المستوى الاقتصادي الذي توجهه فكرة النمو والزيادة، فهم يطلبون زيادة الإنتاج، سواء كان مفيداً أو ضاراً أو حتى مميتاً.
3 ـ وبالنسبة للنواحي السياسية والعلاقات الداخلية والخارجية بين الدول،
فالعنف هو الذي يسيّرها، أي مصالح الأشخاص والطبقات والشعوب التي تتصارع
فيها صراعاً رهيباً.
4 ـ وتتميّز النواحي الثقافية بفقدان المعنى والمغزى لهذه الحياة، فهم
يريدون أن يكون الفن للفن، والعلم للعلم، والاختصاص لمجرد الاختصاص، وأن
تكون الحياة في سبيل لا شيء.
5 ـ أما في العقائد، فقد أضاعوا معنى السيطرة العلوية الإلهية، وبذلك تمّ
إغفال البعد الحقيقي للإنسان في إنسانيته، وتعذّر إمكان الفصل بين النظام
والفوضى الموجودة.
إن الحضارة الفرعونية التي يتحدث عنها القرآن، كانت تريد أن تجعل الحياة لا
معنى لها، أو بمعنى آخر، تريد أن تجعلها مقتصرةً على تأمين الحاجيات
وقائمةً على الصدف.
أما الحضارات الأخرى غير الإسلامية، فلا نجد فيها حالياً إلاّ الجهل بمعنى حياتنا وبمعنى مماتنا.
طريق الحضارة الغربية طريق مسدود
فهذه الثقافة الغربية تقودنا إلى الطريق المسدود، وإذا تابعنا الخطة نفسها، فمعنى ذلك الانتحار لأهل هذا الكوكب، لأن من دعائمها:
1 ـ الفصل بين العلم والحكمة، أي الفصل بين الوسائل والغايات.
2 ـ تحويل جميع الحقائق إلى مفاهيم مغلوطة، تبعد الجمال والحب والعقيدة وتفقد الحياة معناها.
3 ـ جعل الأفراد والجماعات هي المركز الأساسي للاهتمام.
4 ـ إنكار الألوهية، أي السعي للتخلّص من متطلباتها بإبعاد الإبداع والحرية والأمل.
جحد الغربيين للفكر والتراث الإسلامي
ويدعي الغرب أن هذه الثقافة انتقلت إليه من مصدرين:
مصدر إغريقي وروماني، ومصدر يهودي مسيحي، وتناسى عمداً المصدر الثالث لهذا الإرث، وهو التراث العربي الإسلامي.
لقد غضّوا من قدر الميراث العربي الإسلامي لسببين:
1 ـ لادّعائهم بأنهم لم يجدوا فيه إلا نقلاً للثقافات القديمة ولديانات
الماضي وترجمةً للتراث الإغريقي الروماني وإنكاراً في الوقت نفسه للعقيدة
المسيحية ومدخلاً لبعض العقائد الفاسدة من وجهة نظرهم.
2 ـ إنهم لم يشاؤوا أن يرو إلا مقدمةً للثقافة الأوروبية، ما يجعله من اختصاص دارسي الماضي.
وفي ظلّ نظرتهم هذه، يجعلون الإسلام لا يحوي شيئاً جديداً ولا شيئاً حياً، فهو لا يحيا إلا في الماضي، ولا يمكن أن يعدنا بشيء.
هذا الاتجاه المزدوج هو الذي يجب علينا أن نحاربه، لأنه يمنعنا من فهم
الحاضر ومن بناء المستقبل. لهذا السبب، أسمح لنفسي بالبحث في هاتين
الفكرتين الحضاريتين للإسلام.
أولاً: ليس صحيحاً أن الفكر الإسلامي كان مجرّد فكر مترجم ومنقول عن الفكر
اليوناني، فالرياضيات اليونانية مبنية على نظرية المحدود، بينما نجد
الرياضيات عند العرب مبنية على نظرية غير المحدود.
والمنطق اليوناني كان عبارةً عن مجرد تفكير، بينما العلم العربي تجريبـي،
وفن البناء اليوناني كان يعتمد على الثوابت والخطوط المستقيمة، أما المساجد
الإسلامية فقد كانت عكس المعبد اليوناني، إذ تشكل بأقواسها وقبابها
سيمفونية فنية رائعة، والفلسفة العربية كانت فلسفة العمل، إذ لم يدونوا
نظريات حول المادة والمعرفة ويكتفوا بها.
ويمكننا إيراد أمثلة كثيرة تؤكد هذه الحقائق: فالمأساة اليونانية لم تناسب
الفكر الإسلامي، كما أن الشعر العربي لم يناسب الفكر اليوناني وقيمه.
ثانياً: إنه ليس صحيحاً أن العلم العربي كان مجرد مقدمة للعلم الغربي الحاضر، فالعلم العربي عكس موقفنا الفلسفي الذي يؤمن بالحتمية.
إن العرب لا يفرقون ولا يفصلون بين العلم والحكمة، أي أنهم لا يضيعون
الهدف، ويضعون نصب أعينهم المعنى والنهاية لكلِّ عمل، ولا يعتبرون الحوادث
حتماً واقعاً، إنما مجرد إشارة، حتى في الأحداث الطبيعية، وأوضح ما يكون
ذلك في أحاديث الرسول(ص)، فهي لا تفصل بين الأمور فيما بينها، وإنما ترى
الجزء بالنسبة للمجموع وتعطيه معنى، وهذه النسبة تشمل كل الأشياء من
المركَّبة والبسيطة وتعتبرها مقدسة بانتمائها إلى الله.
وتغاضينا اليوم عن (المعنى) وعن (القوة العلوية) هو الذي جعل العلم ينحدر،
وساعد في تحوّل السياسة أيضاً إلى ميكافيلية، وذلك منذ الاهتمام بالنمو
العددي الكمي وجعله هدفاً لنا دون الأخذ بعين الاعتبار الإنسان ومصلحته
وازدهاره.
الغرب اقتبس أسس يقظته من العرب والإسلام:
إن النهضة الغربية باعتمادها على الحضارة الإغريقية الرومانية لم تبدأ في
الحقيقة في إيطاليا، ولكنها بدأت من إسبانيا قبل ذلك بفترة طويلة، من إشعاع
العلم والثقافة العربيين الإسلاميين. ولكن النهضة الغربية لم تستفد من
الحضارة العربية الإسلامية إلا طريقتها التجريبية وأساليبها الفنية، ولم
تأخذ العقيدة التي توجهها إلى الله، ولم تعتبر المحافظة على هذه العقيدة
بمثابة خدمة جليلة للبشرية.
واليوم، نجد أنفسنا كما كان العالم أيام الرسول(ص)، حين كانت تتجاذبه قوتان
عظيمتان، هما الامبراطورية البيزنطية والامبراطورية الساسانية في إيران ـ
وكلتاهما كانتا في طريق الانحلال ـ واليوم نجد قوتين عظيمتين هما الولايات
المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي، تحاولان تقسيم العالم إلى كتلتين،
وتدعي كل قوة منهما لنفسها مبادىء وأيديولوجيات تتعارض مع مبادىء القوة
الأخرى، بينما هما ترتكزان على نفس النموذج من الثقافة الفرعونية القديمة
الذي يوصلهما إلى طرق مسدودة متشابهة تقود إلى إفلاس البشرية. في هذه
الأزمة التي نتلمّس فيها الغايات، أو بالأحرى في غياب هذه الغايات، يمكن
للإسلام أن يقدم للعالم ما ينقصه وهو معنى الحياة.
من ميزات الثقافة والحضارة الإسلامية:
1 ـ فالإسلام دين الوحدة، وهو بذلك دين المعنى والجمال، بينما يقوم عالمنا
اليوم على التنافس العددي الكمي، وتبدو الأحداث وكأنها محصلة قوى عمياء
غاشمة للمجابهة والعنف.
2 ـ إن القرآن يعلّمنا أن نعتبر الكون وكأنه وحدة يقوم الإنسان مع داخلها
بالمشاركة في أداء واكتشاف معنى للحياة، بينما نسياننا للخالق يجعل منا
أشخاصاً يعيشون على هامش الحياة ويخضعون لحاجات ومصادفات خارجية. إن تذكرنا
لله في صلاتنا يجعلنا نفهم مصدر وجودنا، وهو مصدر كل شيء في الوجود.
3 ـ إن القرآن يعلّمنا أن نرى في كلِّ حادث وفي كل شيء آية من آيات الله
ورمزاً لوجود أعلى يسيِّرنا، ويسير الطبيعة والمجتمع، وهدف الدين الرئيسي
هو التناسق والوحدة الصادرة عن الله والعائدة إليه، ما يجعل الإنسان
إنساناً هو اتجاهه إلى تحقيق إرادة الله، فكل شيء في هذا العالم، بالتأكيد
يخضع لإرادة الله، فالحجر في سقوطه، والنبات في نموه، والحيوان في غرائزه،
كلها تخضع لله، ولكن هذا الخضوع لا يتوقف على إرادتها، فهي لا تستطيع أن
تهرب من النواميس التي تحكمها، بينما البشر وحدهم هم الذين يستطيعون.
4 ـ ومن هنا، يصبح الإنسان مسلماً بمطلق إرادته وبمحض مشيئته واختياره، وهو
يتذكر الأمر السامي الذي يجعل لحياته معنى، وهو مسؤول مسؤولية كاملة عن
مصيره، ما دام أن له مطلق الحرية في أن يرفض أو أن يخضع لإرادة الله.
لقد جاء الرسل إلى جميع الشعوب، يدعونهم إلى أن يحددوا إيمانهم بالله
وبتعاليمه، ولقد كان إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وكثير غيرهم من أنبياء
الإسلام يحملون هذه الرسالة الخالدة.
5 ـ والعقل الذي لا يكتفي بربط سبب بآخر، وينتقل من نتيجة إلى ما بعدها
ليتوصل إلى النتيجة النهائية، هو عقل متفتح مذعن لرسالات السماء، يستفيد من
هدايتها ونورها، ولما كانت هذه الرسالات قد جاءت لتنير طريق العقل، فهي
كما ورد عنها "نور على نور".
أثر الصلاة على نفس الإنسان وعلى المجتمع:
واستجابة الإنسان لهذه الرسالات تتجلّى في الصلاة، فالله سبحانه وتعالى مع
عباده المؤمنين من البشر أينما كانوا، وحيثما اتجهوا، وما داموا قد
استجابوا بتحركهم نحو الله، وذلك وفق ما جاء في القسم الثاني من الشهادة
بالنسبة لقسمها الأول، إذ إن ترتيب حركات الصلاة يتناسب مع ظهور واختفاء
الكواكب ويدخل الإنسان ضمن النظام الكوني في حركات صلاته، فهي تعيد كل
مستويات الوجود إلى نفس الإنسان.
إنّ الإنسان عندما يصلي ينتصب واقفاً كالجبال والسنابل والشجر، وهو يركع
ويعود إلى الوقوف، كما تختفي الكواكب ثم تظهر، وينحني كأغصان النخيل، أو
كما تنحني المخلوقات الحية نحو الأرض وكذلك عباد الله رؤوسهم نحو مصدر
الحياة.
هذه الصلاة لا تربط الإنسان بالطبيعة والنظام الشمسي فقط، ولكن تربطه مع
الإنسانية بأسرها. فالقبلة في جميع أنحاء الدنيا، تشكِّل دوائر مركزها
واحد، وهي تمثل الوحدة الشاملة، ومواقيت الصلاة التي تتغير حسب خطوط العرض،
تتيح في كل لحظة أن يقوم شخص ويركع آخر، وتستمر حركة العبادة طيلة الوقت
دون انقطاع، ما يمثل استمرار العبادة حول الأرض، فإذا أردنا أن نعبر عنها
بأعمال طبيعية، فإن وحدة الإسلام تشمل كل العالم.
حاجة الغرب إلى الإسلام
إن الغرب الآن بحاجةٍ إلى الإسلام أكثر من أيِّ وقت مضى، ليعطي للحياة
معنى، وللتاريخ مغزى، وحتى يغير أسلوب الغرب في الفصل بين العلم والحكمة أو
فصل التفكير عن الوسائل وفصل التفكير عن النتائج.
فالهدف الأساسي للعلم والتقنية في الحضارة الغربية لا يعدو فكرة السيطرة،
وتأمين مصالح الأفراد والجماعات والأمم، تماماً كما تؤمن هذه الحاجات
المشتركة من غذاء وكساء وحماية من العدوان والمهاجمة.
أما العلم الإسلامي فمحركه الأساسي هو البحث عن آيات الله في الطبيعة وفي
التاريخ لتحقيق مشيئة الله، دون الابتعاد عن الأسباب والنواميس الكونية.
في الغرب يجعلون الإنسان منافساً لإنسان آخر، يحاول أن يستخدم علومه
للتغلّب عليه، أما في الإسلام، فالإنسان خليفة الله في الأرض ليوجد فيها
الجمال الذي يليق بمشيئة الله، كما أن الإنسان لا يضع حاجزاً بين العلم
والإيمان، بل على العكس من ذلك، يربط بينهما باعتبارهما وحدة متكاملة غير
قابلة للتجزئة، ولا يفصل بين البحث عن الوسائل والنواميس وبين البحث عن
النتائج والمعاني المترتبة عليها.
إنه لا يفصل بين ما يعلمنا إياه الفن والاختصاص الذي يعطينا السيطرة على
الأشياء، وبين عبادة المصدر الأول الذي أوجدها. وكذلك فالإسلام لا يفصل بين
العقيدة وبين الاقتصاد والسياسة، بل يربطهما برباط لا ينفصم، وعندما نريد
أن نجسِّد معنى مالك كل شيء والقادر على كلِّ شيء، فالله وحده هو الملك وهو
وحده الآمر الحاكم العالم، نجد أن المفهوم الإسلامي للدولة وللحق هو عكس
مفهوم الدولة والحق عند الرومان، فيختلف تبعاً لذلك تعريف الملكية في
الإسلام بالنسبة للحقوق، ونجد اختلافاً وتميزاً عن الحقوق في الشرائع
الرومانية والرأسمالية كما تختلف مفاهيمها.
فالله هو وحده المالك، وإدارة خيرات هذا الكون وظيفة اجتماعية، فاستعمال
الملكية له أهداف أبعد من الفرد ومن فائدة الفرد الشخصية، وهنا يبرز التضاد
بين نظرية الفردية ونظرية الجماعة الإسلامية كفكرة.
وقولنا إن الله وحده هو الحاكم، يجعلنا نستبعد حكم الملوك على أساس الحق
الإلهي، مثل حكم لويس الرابع عشر في الغرب الذي كان (بوسويه) يقول عنه إنه
وكيل الله على الأرض، كما نستبعد الديمقراطية التي ترتكز في حكمها على شخص
أو حزب فقط.
فنداء الإيمان عند المسلمين "الله أكبر" يفسر معنى ملكية كل شيء والقدرة
على كل شيء ومعرفة كل شيء، وهذا نداء الحرية الحقيقية، لأنه تأكيد على
أبعاد الإنسان السامية الحقيقية، أي أنه يستطيع (الانفلات) من ماضيه ومن
غرائزه ومن طبيعته ومن عاداته، ويستطيع أن يصعدها ويردها إلى القوة
الإلهية.
والإنسان وحده هو الذي يملك هذه الإمكانية للفصل، مع هذا الإرغام القديم، بين الدوافع وماضيها، وتقديم مستقبل مشرق للإنسانية.
فتاريخ البشر لا يشبه التطور الحيواني، على اعتبار أنه مسرحية قد كتبت
مسبقاً بالنسبة لنا، وما علينا إلا أن نلعب فيها أدوارنا الأبدية.
والتاريخ هو تطور مستمر للإنسان مع تتابع السنين والأعوام، ولدى الإنسان
إمكانية استمرار النموّ الحالي الانتحاري، بحصولنا فنياً على أدوات إزالة
كل آثار الحياة عن سطح هذا الكوكب، وإمكانية إنهاء ثلاثة ملايين من السنين
من تاريخ البشر، بل إمكانية إلحاق التعفّن بالتاريخ.
مسؤولية المسلمين اليوم
نحن مسؤولون عن تاريخنا، وإن هذه الأمانة الإلهية التي استلمناها، والتي
يقول فيها القرآن: {إنّا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين
أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً}
[الأحزاب:72].
وهناك نوعان من الحرية: حرية الحيوان في إشباع حاجاته من الطعام والسكن والكفاح، وهي كلها حيوانية.
والحرية الإلهية التي تؤكد على الحاجات الإنسانية البحتة، وعلى معنى حياتنا
ومماتنا، أي أن نفتش عن هدف المولى عز وجل من خلق هذه الحياة وأن نسعى
لتحقيقه.
ونحن نملك من الآيات ما يمكننا من التوصل إلى الإيمان، ابتداءً بما يجري في
الطبيعة، وانتهاءً بتعاليم الأنبياء والرسل، مع إمكانية تعرّضنا للوقوع في
الخطأ، وهذا الخطأ هو الذي يجعلنا بشراً، فالإيمان بالغيب يبدأ حيث ينتهي
العقل.
هذه القوة العلويّة الربانية هي الأساس في كلِّ حقيقة إنسانية. إن ما يميز
حكومة المدينة التي أنشأها الرسول(ص) هو هذه الأبعاد التي لا يمكن تجزئتها،
من قوة علوية وجماعة إسلامية، فالرسول أنشأ في المدينة دولةً مثلى، لا
تعتمد على روابط الدم أو ترتكز علىالعلاقة بالأرض لدى المزارعين المقيمين،
كما أنها ليست حكومة مدينة تقوم على أساس وجود أمة لها سوق واحدة، وليست
حكومة تنبثق عن ثقافة موحدة على أساس عرقي أو جغرافي أو ثقافي أو على
الماضي، إنما هي مجتمع رسولي مبني على عقيدة مشتركة تحت رعاية الله، مجتمع
مبارك مفتوح للإنسانية جمعاء.
إن مجتمع المدينة يفسح المجال لإيجاد القاسم المشترك بين المجتمعات
الإسلامية، قوة علوية إلهية، وذلك بالمقابلة مع مجتمعاتنا التي تتضخم وتنمو
ولا يعتبر المستقبل فيها إلا امتداداً للماضي والحاضر.
و"الجماعة" هنا تقابل الفردية التي تؤدي إلى كفاح الجميع ضد الجميع، فالقوة
العلوية الإلهية وعقلية الجماعة هما البعدان الوحيدان المتمثّل في الإله
من جانب، والإنسان من جانب آخر، اللذان يحتاجهما الغرب اليوم حاجة ماسّةً،
ومع ذلك، فهنالك اعتراض يثيره غالباً المفكرون الغربيون، وهو ما حاولنا أن
نبدأ بالإجابة عليه: إذا كان هذا القانون الإلهي قد أوحى به وبشكل نهائي في
القرآن، وإذا كان محمد هو آخر الأنبياء، ألا يحكم الإسلام على المجتمع
والدولة بالتحجر والجمود؟
لقد حاولنا أن نبدأ في الإجابة على هذا السؤال، لأنه بمجرد القول إن هذا
الشرع إلهي المصدر، وإن آيات القرآن قد أنزلها الله، ولها قيمة غير محدودة،
إن هذا القول لا يبرر مطلقاً أن نخرج من التاريخ وأن نجمد خلال التاريخ كل
أمر ورد عن الله، بل على العكس من ذلك، فإننا نجد في القرآن ذاته مبدأ
للحركة والحياة ـ كما يذكره محمد إقبال ـ فقد ورد تكراراً في القرآن أن
الله لم يرسل رسولاً إلى أمة لكي يعلمهم رسالة الله إلا بلغة أمته، فنحن
نجد ثلاثة أنبياء هم إبراهيم وموسى وعيسى، وهم من أنبياء المسلمين قد جاءوا
برسالة الإسلام التي أتمّها النبي محمد(ص).
كما يجب أن نذكر أنّ كل وحي ورد في القرآن ونقله النبي، سواء في مكة أو في
المدينة، هو جواب إلهي لقضية محدّدة، ونحن لا نثير صبغة الوضع الإلهي لهذا
الوحي إذا وضعناه في موقعه التاريخي والثقافي في حياة شعب. فالإسلام قد
امتدّ إلى عصور أخرى من الحضارات، اختلفت فيها حاجات الدولة وتراكيبها، حيث
نجمت مشاكل عديدة، فقام كبار الفقهاء بمحاولة تفسير الكلام الإلهي لمواجهة
المواقف الجديدة، ولم يكن ممكناً أن نستنتج من هذه الآيات القرآنية ومن
الشرائع السماوية ما نبني على أساسه دولة مختلفة عن حكومة المدينة ـ على
الطريقة التي يسير عليها "بوسويه" في التقليد الكاثوليكي، في كتابه السياسي
الذي استخلصه من الكتاب المقدس ـ لقد كانت استنتاجات "بوسويه" وهمية تهدف
إلى إيجاد تبرير شرعي لملكية لويس الرابع عشر المطلقة، وهذه المحاولة التي
قام بها "بوسويه" تشبه ما قام به في العالم الإسلامي (الماوردي) في كتابه
(الأحكام السلطانية)، الذي يرسم فيه أجهزة الحكم عندما كانت في طريقها إلى
التفكك إبان الخلافة العباسية بشكل نظري لا يستند فيه إلى القرآن وإنما إلى
التقليد.
ومن الممكن استناداً إلى الوحي القرآني، أن نجد في الطريق الصحيح للإسلام
حلولاً للمشاكل التي تفرضها الحياة اليوم، دون أن نمزج ذلك بتقليد النماذج
الأمريكية والسوفيتية، أو أن نخلط بين الاتجاه نحو العصرية مع الاتجاه نحو
الغرب.
فليس القرآن ولا الإسلام هما المسؤولين عن وضع المسلمين اليوم، وإنما
الرجعية، المحافظة، والجمود والتمسّك بالحرف، أي أنه في جميع العصور "رفض
الاجتهاد".
وهذا الرفض ـ كما حدث في المسيحية ـ همه أن يظهر أي شريعة أو عقيدة بنفس
الثوب الذي ظهرت فيه في عصر من العصور، إن هذا الرفض للاجتهاد، سواء في
الدين أو في السياسة، يقود إلى تقليد وإعادة نماذج بالية، قد عفا عليها
الزمان ربما تلاءمت في الماضي مع حاجات عصرها وشعوبها، ولكنها لا تسمح
بحلِّ المشاكل الحالية.
فالتقليد يجعل فقهاء الإسلام يجمعون على إباحة كل ما ليس هناك نص واضح صريح
بتحريمه، لذا على كل جيل أن يبذل الجهد في تفسير النصوص، كما يدعونا إلى
ذلك القرآن في كل صفحة من صفحاته، وهذا يسمح بحل المشاكل التي تعترضنا وفق
العقلية التي أوحت إلى الرسول طريقة الحكم في دولة المدينة، وفي الإسلام
إمكانات وتطلّعات أكبر من ذلك، حتى في ذلك الزمن الذي بلغ فيه ذروته،
ونظراً لإفلاس النموذجين الأمريكي والسوفيتي، يمكن للإسلام إفساح مجال
الأمل لعالم اليوم، إذا قضينا على فكرة سدِّ باب الاجتهاد الذي حكم به خلال
أجيال، فقضى على الإسلام بالتراجع، وإذا أدخلنا المبادىء المنشطة التي
تبرز عظمة الإسلام أولاً من ناحية "الإيجابية"، بحيث تخضع الناس والأعمال
لقانون يهتم بالنتائج وبالمعنى.
حتميـة الحـل الإسلامي
أما بالنسبة للتكنوقراطيين، فإننا نجدهم دائماً يتساءلون كيف؟ ولا نجدهم يسألون مطلقاً لماذا؟.
ونودّ أن نذكر بأن الاختصاص لمجرد الاختصاص، والعلم لمجرد العلم، والفن
لمجرد الفن، هو نسيان مميت للهدف، بإحلال الوسائل بدلاً من النتائج، ويبقى
طلب المعنى لهذه الأعمال والهدف منها هو الذي يقودنا إلى ذكر الله.
وبالنسبة "للفردية" التي تجعل من الفرد محور كل شيء، فيمكن استبدالها بالشعور "بالجماعة"، أي بعالم مركزه في غيره.
وإذا نظرنا إلى "الحتمية" التي تقود إلى عواقب مميتة وإلى عدم الكفاية التي
تهدد الإنسان في مستقبله باعتباره امتداداً لماضيه وحاضره، فيمكننا
مواجهتها، وتحطيم الطوق من حول الإنسان، وفتح مستقبله بشكل غير محدود،
بتأكيدنا على القوة العلوية الإلهية التي تنتشلنا من نمو كمي عددي أصبح
وثناً يعبد، وإلهاً مزوراً يسجد له من دون الله، وأعتقد أن هذا أصبح
بالنسبة لمسلمي الغرب أمراً ضرورياً، فالإسلام هو تتويج للسلالة
الإبراهيمية والذي يدعو الإنسان إلى أن يفتش ويبحث عن نهايته العظمى،
ومآله، كما يمكن للإسلام أن يعيد إحياء الأمل في مجتمعاتنا الغربية
المتأثرة بالفردية، بطريقة من النمو تقود العالم بأجمعه إلى الانتحار،
ولكننا لن نحقق هذا الأمل بشكل كامل إلا إذا وعينا دائماً ما كتبه (فوريس)،
بأننا لن نكون أوفياء للأجداد بالمحافظة على رفاتهم، ولكن بنقل الشعلة
التي أوقدوها.
أريد أن أتحدّث اليوم عن الإسلام بشكل عام، ولا عن الإسلام وما جلبه
للحضارة العالمية، وإنما أريد أن أتحدث عن إمكانية انتشار الإسلام في
العالم الغربي في أيامنا هذه.
تمهـيد
عندما نشأت الدعوة إلى الإسلام، كان العالم حينئذٍ غارقاً في شتى ألوان
الفوضى والانحطاط العام، فالامبراطوريات الكبرى، من بيزنطية وفارسية
وإمبراطورية القبط ومملكة الويز يغوط، كانت في دور التفكك والانهيار.
ولما جاء الإسلام ونزلت آيات القرآن، معلنةً أن الخلق والأمر بيد الله
سبحانه وتعالى، عاد لملايين البشر ثقتهم بإنسانيتهم ذات المصدر الإلهي،
واتجهوا إلى صياغة حياتهم الاجتماعية صياغةً جديدة.
وهنا يمكن أن يطرح علينا سؤال: أليس الإسلام قد قدّم للإنسانية فكرة السلطة
العلوية، كما قدم فكرة الجماعة والعمل لصالح المجتمع، في عالم تناسوا فيه
القوى الإلهية، وفي مجتمع يتجه بكليته إلى طريق الفردية، ما جعل الوضع يبدو
غير قابل للاستمرار، وجعل الثورات على الطريقة الغربية مستحيلة؟
نتائج الحضارة الغربية
إننا بعد خمسة قرون من سيادة الغرب سيادة تامة ـ بدون منازع ـ يمكن تلخيص نتائج حضارته فيما يلي:
1 ـ على الصعيد الاجتماعي: لقد صرف للتسلّح على سطح هذه الكرة الأرضية عام
1982م مبلغ 650 مليار دولار، ولو وزع هذا المبلغ على أفراد البشرية لأصاب
الفرد الواحد أربعة أطنان من المتفجرات، وفي نفس تلك السنة، توفي في العالم
الثالث خمسون مليوناً بسبب الجوع أو سوء التغذية.
ومن الصعب أن نسمي خط سير الحضارة الغربية، وتوصلها إلى إمكانية تدمير
الحياة على سطح الأرض وإنهاء ثلاثة ملايين سنة من تاريخ البشر، لا يمكن أن
نسمي ذلك بحال من الأحوال تقدماً.
2 ـ أما على المستوى الاقتصادي الذي توجهه فكرة النمو والزيادة، فهم يطلبون زيادة الإنتاج، سواء كان مفيداً أو ضاراً أو حتى مميتاً.
3 ـ وبالنسبة للنواحي السياسية والعلاقات الداخلية والخارجية بين الدول،
فالعنف هو الذي يسيّرها، أي مصالح الأشخاص والطبقات والشعوب التي تتصارع
فيها صراعاً رهيباً.
4 ـ وتتميّز النواحي الثقافية بفقدان المعنى والمغزى لهذه الحياة، فهم
يريدون أن يكون الفن للفن، والعلم للعلم، والاختصاص لمجرد الاختصاص، وأن
تكون الحياة في سبيل لا شيء.
5 ـ أما في العقائد، فقد أضاعوا معنى السيطرة العلوية الإلهية، وبذلك تمّ
إغفال البعد الحقيقي للإنسان في إنسانيته، وتعذّر إمكان الفصل بين النظام
والفوضى الموجودة.
إن الحضارة الفرعونية التي يتحدث عنها القرآن، كانت تريد أن تجعل الحياة لا
معنى لها، أو بمعنى آخر، تريد أن تجعلها مقتصرةً على تأمين الحاجيات
وقائمةً على الصدف.
أما الحضارات الأخرى غير الإسلامية، فلا نجد فيها حالياً إلاّ الجهل بمعنى حياتنا وبمعنى مماتنا.
طريق الحضارة الغربية طريق مسدود
فهذه الثقافة الغربية تقودنا إلى الطريق المسدود، وإذا تابعنا الخطة نفسها، فمعنى ذلك الانتحار لأهل هذا الكوكب، لأن من دعائمها:
1 ـ الفصل بين العلم والحكمة، أي الفصل بين الوسائل والغايات.
2 ـ تحويل جميع الحقائق إلى مفاهيم مغلوطة، تبعد الجمال والحب والعقيدة وتفقد الحياة معناها.
3 ـ جعل الأفراد والجماعات هي المركز الأساسي للاهتمام.
4 ـ إنكار الألوهية، أي السعي للتخلّص من متطلباتها بإبعاد الإبداع والحرية والأمل.
جحد الغربيين للفكر والتراث الإسلامي
ويدعي الغرب أن هذه الثقافة انتقلت إليه من مصدرين:
مصدر إغريقي وروماني، ومصدر يهودي مسيحي، وتناسى عمداً المصدر الثالث لهذا الإرث، وهو التراث العربي الإسلامي.
لقد غضّوا من قدر الميراث العربي الإسلامي لسببين:
1 ـ لادّعائهم بأنهم لم يجدوا فيه إلا نقلاً للثقافات القديمة ولديانات
الماضي وترجمةً للتراث الإغريقي الروماني وإنكاراً في الوقت نفسه للعقيدة
المسيحية ومدخلاً لبعض العقائد الفاسدة من وجهة نظرهم.
2 ـ إنهم لم يشاؤوا أن يرو إلا مقدمةً للثقافة الأوروبية، ما يجعله من اختصاص دارسي الماضي.
وفي ظلّ نظرتهم هذه، يجعلون الإسلام لا يحوي شيئاً جديداً ولا شيئاً حياً، فهو لا يحيا إلا في الماضي، ولا يمكن أن يعدنا بشيء.
هذا الاتجاه المزدوج هو الذي يجب علينا أن نحاربه، لأنه يمنعنا من فهم
الحاضر ومن بناء المستقبل. لهذا السبب، أسمح لنفسي بالبحث في هاتين
الفكرتين الحضاريتين للإسلام.
أولاً: ليس صحيحاً أن الفكر الإسلامي كان مجرّد فكر مترجم ومنقول عن الفكر
اليوناني، فالرياضيات اليونانية مبنية على نظرية المحدود، بينما نجد
الرياضيات عند العرب مبنية على نظرية غير المحدود.
والمنطق اليوناني كان عبارةً عن مجرد تفكير، بينما العلم العربي تجريبـي،
وفن البناء اليوناني كان يعتمد على الثوابت والخطوط المستقيمة، أما المساجد
الإسلامية فقد كانت عكس المعبد اليوناني، إذ تشكل بأقواسها وقبابها
سيمفونية فنية رائعة، والفلسفة العربية كانت فلسفة العمل، إذ لم يدونوا
نظريات حول المادة والمعرفة ويكتفوا بها.
ويمكننا إيراد أمثلة كثيرة تؤكد هذه الحقائق: فالمأساة اليونانية لم تناسب
الفكر الإسلامي، كما أن الشعر العربي لم يناسب الفكر اليوناني وقيمه.
ثانياً: إنه ليس صحيحاً أن العلم العربي كان مجرد مقدمة للعلم الغربي الحاضر، فالعلم العربي عكس موقفنا الفلسفي الذي يؤمن بالحتمية.
إن العرب لا يفرقون ولا يفصلون بين العلم والحكمة، أي أنهم لا يضيعون
الهدف، ويضعون نصب أعينهم المعنى والنهاية لكلِّ عمل، ولا يعتبرون الحوادث
حتماً واقعاً، إنما مجرد إشارة، حتى في الأحداث الطبيعية، وأوضح ما يكون
ذلك في أحاديث الرسول(ص)، فهي لا تفصل بين الأمور فيما بينها، وإنما ترى
الجزء بالنسبة للمجموع وتعطيه معنى، وهذه النسبة تشمل كل الأشياء من
المركَّبة والبسيطة وتعتبرها مقدسة بانتمائها إلى الله.
وتغاضينا اليوم عن (المعنى) وعن (القوة العلوية) هو الذي جعل العلم ينحدر،
وساعد في تحوّل السياسة أيضاً إلى ميكافيلية، وذلك منذ الاهتمام بالنمو
العددي الكمي وجعله هدفاً لنا دون الأخذ بعين الاعتبار الإنسان ومصلحته
وازدهاره.
الغرب اقتبس أسس يقظته من العرب والإسلام:
إن النهضة الغربية باعتمادها على الحضارة الإغريقية الرومانية لم تبدأ في
الحقيقة في إيطاليا، ولكنها بدأت من إسبانيا قبل ذلك بفترة طويلة، من إشعاع
العلم والثقافة العربيين الإسلاميين. ولكن النهضة الغربية لم تستفد من
الحضارة العربية الإسلامية إلا طريقتها التجريبية وأساليبها الفنية، ولم
تأخذ العقيدة التي توجهها إلى الله، ولم تعتبر المحافظة على هذه العقيدة
بمثابة خدمة جليلة للبشرية.
واليوم، نجد أنفسنا كما كان العالم أيام الرسول(ص)، حين كانت تتجاذبه قوتان
عظيمتان، هما الامبراطورية البيزنطية والامبراطورية الساسانية في إيران ـ
وكلتاهما كانتا في طريق الانحلال ـ واليوم نجد قوتين عظيمتين هما الولايات
المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي، تحاولان تقسيم العالم إلى كتلتين،
وتدعي كل قوة منهما لنفسها مبادىء وأيديولوجيات تتعارض مع مبادىء القوة
الأخرى، بينما هما ترتكزان على نفس النموذج من الثقافة الفرعونية القديمة
الذي يوصلهما إلى طرق مسدودة متشابهة تقود إلى إفلاس البشرية. في هذه
الأزمة التي نتلمّس فيها الغايات، أو بالأحرى في غياب هذه الغايات، يمكن
للإسلام أن يقدم للعالم ما ينقصه وهو معنى الحياة.
من ميزات الثقافة والحضارة الإسلامية:
1 ـ فالإسلام دين الوحدة، وهو بذلك دين المعنى والجمال، بينما يقوم عالمنا
اليوم على التنافس العددي الكمي، وتبدو الأحداث وكأنها محصلة قوى عمياء
غاشمة للمجابهة والعنف.
2 ـ إن القرآن يعلّمنا أن نعتبر الكون وكأنه وحدة يقوم الإنسان مع داخلها
بالمشاركة في أداء واكتشاف معنى للحياة، بينما نسياننا للخالق يجعل منا
أشخاصاً يعيشون على هامش الحياة ويخضعون لحاجات ومصادفات خارجية. إن تذكرنا
لله في صلاتنا يجعلنا نفهم مصدر وجودنا، وهو مصدر كل شيء في الوجود.
3 ـ إن القرآن يعلّمنا أن نرى في كلِّ حادث وفي كل شيء آية من آيات الله
ورمزاً لوجود أعلى يسيِّرنا، ويسير الطبيعة والمجتمع، وهدف الدين الرئيسي
هو التناسق والوحدة الصادرة عن الله والعائدة إليه، ما يجعل الإنسان
إنساناً هو اتجاهه إلى تحقيق إرادة الله، فكل شيء في هذا العالم، بالتأكيد
يخضع لإرادة الله، فالحجر في سقوطه، والنبات في نموه، والحيوان في غرائزه،
كلها تخضع لله، ولكن هذا الخضوع لا يتوقف على إرادتها، فهي لا تستطيع أن
تهرب من النواميس التي تحكمها، بينما البشر وحدهم هم الذين يستطيعون.
4 ـ ومن هنا، يصبح الإنسان مسلماً بمطلق إرادته وبمحض مشيئته واختياره، وهو
يتذكر الأمر السامي الذي يجعل لحياته معنى، وهو مسؤول مسؤولية كاملة عن
مصيره، ما دام أن له مطلق الحرية في أن يرفض أو أن يخضع لإرادة الله.
لقد جاء الرسل إلى جميع الشعوب، يدعونهم إلى أن يحددوا إيمانهم بالله
وبتعاليمه، ولقد كان إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وكثير غيرهم من أنبياء
الإسلام يحملون هذه الرسالة الخالدة.
5 ـ والعقل الذي لا يكتفي بربط سبب بآخر، وينتقل من نتيجة إلى ما بعدها
ليتوصل إلى النتيجة النهائية، هو عقل متفتح مذعن لرسالات السماء، يستفيد من
هدايتها ونورها، ولما كانت هذه الرسالات قد جاءت لتنير طريق العقل، فهي
كما ورد عنها "نور على نور".
أثر الصلاة على نفس الإنسان وعلى المجتمع:
واستجابة الإنسان لهذه الرسالات تتجلّى في الصلاة، فالله سبحانه وتعالى مع
عباده المؤمنين من البشر أينما كانوا، وحيثما اتجهوا، وما داموا قد
استجابوا بتحركهم نحو الله، وذلك وفق ما جاء في القسم الثاني من الشهادة
بالنسبة لقسمها الأول، إذ إن ترتيب حركات الصلاة يتناسب مع ظهور واختفاء
الكواكب ويدخل الإنسان ضمن النظام الكوني في حركات صلاته، فهي تعيد كل
مستويات الوجود إلى نفس الإنسان.
إنّ الإنسان عندما يصلي ينتصب واقفاً كالجبال والسنابل والشجر، وهو يركع
ويعود إلى الوقوف، كما تختفي الكواكب ثم تظهر، وينحني كأغصان النخيل، أو
كما تنحني المخلوقات الحية نحو الأرض وكذلك عباد الله رؤوسهم نحو مصدر
الحياة.
هذه الصلاة لا تربط الإنسان بالطبيعة والنظام الشمسي فقط، ولكن تربطه مع
الإنسانية بأسرها. فالقبلة في جميع أنحاء الدنيا، تشكِّل دوائر مركزها
واحد، وهي تمثل الوحدة الشاملة، ومواقيت الصلاة التي تتغير حسب خطوط العرض،
تتيح في كل لحظة أن يقوم شخص ويركع آخر، وتستمر حركة العبادة طيلة الوقت
دون انقطاع، ما يمثل استمرار العبادة حول الأرض، فإذا أردنا أن نعبر عنها
بأعمال طبيعية، فإن وحدة الإسلام تشمل كل العالم.
حاجة الغرب إلى الإسلام
إن الغرب الآن بحاجةٍ إلى الإسلام أكثر من أيِّ وقت مضى، ليعطي للحياة
معنى، وللتاريخ مغزى، وحتى يغير أسلوب الغرب في الفصل بين العلم والحكمة أو
فصل التفكير عن الوسائل وفصل التفكير عن النتائج.
فالهدف الأساسي للعلم والتقنية في الحضارة الغربية لا يعدو فكرة السيطرة،
وتأمين مصالح الأفراد والجماعات والأمم، تماماً كما تؤمن هذه الحاجات
المشتركة من غذاء وكساء وحماية من العدوان والمهاجمة.
أما العلم الإسلامي فمحركه الأساسي هو البحث عن آيات الله في الطبيعة وفي
التاريخ لتحقيق مشيئة الله، دون الابتعاد عن الأسباب والنواميس الكونية.
في الغرب يجعلون الإنسان منافساً لإنسان آخر، يحاول أن يستخدم علومه
للتغلّب عليه، أما في الإسلام، فالإنسان خليفة الله في الأرض ليوجد فيها
الجمال الذي يليق بمشيئة الله، كما أن الإنسان لا يضع حاجزاً بين العلم
والإيمان، بل على العكس من ذلك، يربط بينهما باعتبارهما وحدة متكاملة غير
قابلة للتجزئة، ولا يفصل بين البحث عن الوسائل والنواميس وبين البحث عن
النتائج والمعاني المترتبة عليها.
إنه لا يفصل بين ما يعلمنا إياه الفن والاختصاص الذي يعطينا السيطرة على
الأشياء، وبين عبادة المصدر الأول الذي أوجدها. وكذلك فالإسلام لا يفصل بين
العقيدة وبين الاقتصاد والسياسة، بل يربطهما برباط لا ينفصم، وعندما نريد
أن نجسِّد معنى مالك كل شيء والقادر على كلِّ شيء، فالله وحده هو الملك وهو
وحده الآمر الحاكم العالم، نجد أن المفهوم الإسلامي للدولة وللحق هو عكس
مفهوم الدولة والحق عند الرومان، فيختلف تبعاً لذلك تعريف الملكية في
الإسلام بالنسبة للحقوق، ونجد اختلافاً وتميزاً عن الحقوق في الشرائع
الرومانية والرأسمالية كما تختلف مفاهيمها.
فالله هو وحده المالك، وإدارة خيرات هذا الكون وظيفة اجتماعية، فاستعمال
الملكية له أهداف أبعد من الفرد ومن فائدة الفرد الشخصية، وهنا يبرز التضاد
بين نظرية الفردية ونظرية الجماعة الإسلامية كفكرة.
وقولنا إن الله وحده هو الحاكم، يجعلنا نستبعد حكم الملوك على أساس الحق
الإلهي، مثل حكم لويس الرابع عشر في الغرب الذي كان (بوسويه) يقول عنه إنه
وكيل الله على الأرض، كما نستبعد الديمقراطية التي ترتكز في حكمها على شخص
أو حزب فقط.
فنداء الإيمان عند المسلمين "الله أكبر" يفسر معنى ملكية كل شيء والقدرة
على كل شيء ومعرفة كل شيء، وهذا نداء الحرية الحقيقية، لأنه تأكيد على
أبعاد الإنسان السامية الحقيقية، أي أنه يستطيع (الانفلات) من ماضيه ومن
غرائزه ومن طبيعته ومن عاداته، ويستطيع أن يصعدها ويردها إلى القوة
الإلهية.
والإنسان وحده هو الذي يملك هذه الإمكانية للفصل، مع هذا الإرغام القديم، بين الدوافع وماضيها، وتقديم مستقبل مشرق للإنسانية.
فتاريخ البشر لا يشبه التطور الحيواني، على اعتبار أنه مسرحية قد كتبت
مسبقاً بالنسبة لنا، وما علينا إلا أن نلعب فيها أدوارنا الأبدية.
والتاريخ هو تطور مستمر للإنسان مع تتابع السنين والأعوام، ولدى الإنسان
إمكانية استمرار النموّ الحالي الانتحاري، بحصولنا فنياً على أدوات إزالة
كل آثار الحياة عن سطح هذا الكوكب، وإمكانية إنهاء ثلاثة ملايين من السنين
من تاريخ البشر، بل إمكانية إلحاق التعفّن بالتاريخ.
مسؤولية المسلمين اليوم
نحن مسؤولون عن تاريخنا، وإن هذه الأمانة الإلهية التي استلمناها، والتي
يقول فيها القرآن: {إنّا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين
أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً}
[الأحزاب:72].
وهناك نوعان من الحرية: حرية الحيوان في إشباع حاجاته من الطعام والسكن والكفاح، وهي كلها حيوانية.
والحرية الإلهية التي تؤكد على الحاجات الإنسانية البحتة، وعلى معنى حياتنا
ومماتنا، أي أن نفتش عن هدف المولى عز وجل من خلق هذه الحياة وأن نسعى
لتحقيقه.
ونحن نملك من الآيات ما يمكننا من التوصل إلى الإيمان، ابتداءً بما يجري في
الطبيعة، وانتهاءً بتعاليم الأنبياء والرسل، مع إمكانية تعرّضنا للوقوع في
الخطأ، وهذا الخطأ هو الذي يجعلنا بشراً، فالإيمان بالغيب يبدأ حيث ينتهي
العقل.
هذه القوة العلويّة الربانية هي الأساس في كلِّ حقيقة إنسانية. إن ما يميز
حكومة المدينة التي أنشأها الرسول(ص) هو هذه الأبعاد التي لا يمكن تجزئتها،
من قوة علوية وجماعة إسلامية، فالرسول أنشأ في المدينة دولةً مثلى، لا
تعتمد على روابط الدم أو ترتكز علىالعلاقة بالأرض لدى المزارعين المقيمين،
كما أنها ليست حكومة مدينة تقوم على أساس وجود أمة لها سوق واحدة، وليست
حكومة تنبثق عن ثقافة موحدة على أساس عرقي أو جغرافي أو ثقافي أو على
الماضي، إنما هي مجتمع رسولي مبني على عقيدة مشتركة تحت رعاية الله، مجتمع
مبارك مفتوح للإنسانية جمعاء.
إن مجتمع المدينة يفسح المجال لإيجاد القاسم المشترك بين المجتمعات
الإسلامية، قوة علوية إلهية، وذلك بالمقابلة مع مجتمعاتنا التي تتضخم وتنمو
ولا يعتبر المستقبل فيها إلا امتداداً للماضي والحاضر.
و"الجماعة" هنا تقابل الفردية التي تؤدي إلى كفاح الجميع ضد الجميع، فالقوة
العلوية الإلهية وعقلية الجماعة هما البعدان الوحيدان المتمثّل في الإله
من جانب، والإنسان من جانب آخر، اللذان يحتاجهما الغرب اليوم حاجة ماسّةً،
ومع ذلك، فهنالك اعتراض يثيره غالباً المفكرون الغربيون، وهو ما حاولنا أن
نبدأ بالإجابة عليه: إذا كان هذا القانون الإلهي قد أوحى به وبشكل نهائي في
القرآن، وإذا كان محمد هو آخر الأنبياء، ألا يحكم الإسلام على المجتمع
والدولة بالتحجر والجمود؟
لقد حاولنا أن نبدأ في الإجابة على هذا السؤال، لأنه بمجرد القول إن هذا
الشرع إلهي المصدر، وإن آيات القرآن قد أنزلها الله، ولها قيمة غير محدودة،
إن هذا القول لا يبرر مطلقاً أن نخرج من التاريخ وأن نجمد خلال التاريخ كل
أمر ورد عن الله، بل على العكس من ذلك، فإننا نجد في القرآن ذاته مبدأ
للحركة والحياة ـ كما يذكره محمد إقبال ـ فقد ورد تكراراً في القرآن أن
الله لم يرسل رسولاً إلى أمة لكي يعلمهم رسالة الله إلا بلغة أمته، فنحن
نجد ثلاثة أنبياء هم إبراهيم وموسى وعيسى، وهم من أنبياء المسلمين قد جاءوا
برسالة الإسلام التي أتمّها النبي محمد(ص).
كما يجب أن نذكر أنّ كل وحي ورد في القرآن ونقله النبي، سواء في مكة أو في
المدينة، هو جواب إلهي لقضية محدّدة، ونحن لا نثير صبغة الوضع الإلهي لهذا
الوحي إذا وضعناه في موقعه التاريخي والثقافي في حياة شعب. فالإسلام قد
امتدّ إلى عصور أخرى من الحضارات، اختلفت فيها حاجات الدولة وتراكيبها، حيث
نجمت مشاكل عديدة، فقام كبار الفقهاء بمحاولة تفسير الكلام الإلهي لمواجهة
المواقف الجديدة، ولم يكن ممكناً أن نستنتج من هذه الآيات القرآنية ومن
الشرائع السماوية ما نبني على أساسه دولة مختلفة عن حكومة المدينة ـ على
الطريقة التي يسير عليها "بوسويه" في التقليد الكاثوليكي، في كتابه السياسي
الذي استخلصه من الكتاب المقدس ـ لقد كانت استنتاجات "بوسويه" وهمية تهدف
إلى إيجاد تبرير شرعي لملكية لويس الرابع عشر المطلقة، وهذه المحاولة التي
قام بها "بوسويه" تشبه ما قام به في العالم الإسلامي (الماوردي) في كتابه
(الأحكام السلطانية)، الذي يرسم فيه أجهزة الحكم عندما كانت في طريقها إلى
التفكك إبان الخلافة العباسية بشكل نظري لا يستند فيه إلى القرآن وإنما إلى
التقليد.
ومن الممكن استناداً إلى الوحي القرآني، أن نجد في الطريق الصحيح للإسلام
حلولاً للمشاكل التي تفرضها الحياة اليوم، دون أن نمزج ذلك بتقليد النماذج
الأمريكية والسوفيتية، أو أن نخلط بين الاتجاه نحو العصرية مع الاتجاه نحو
الغرب.
فليس القرآن ولا الإسلام هما المسؤولين عن وضع المسلمين اليوم، وإنما
الرجعية، المحافظة، والجمود والتمسّك بالحرف، أي أنه في جميع العصور "رفض
الاجتهاد".
وهذا الرفض ـ كما حدث في المسيحية ـ همه أن يظهر أي شريعة أو عقيدة بنفس
الثوب الذي ظهرت فيه في عصر من العصور، إن هذا الرفض للاجتهاد، سواء في
الدين أو في السياسة، يقود إلى تقليد وإعادة نماذج بالية، قد عفا عليها
الزمان ربما تلاءمت في الماضي مع حاجات عصرها وشعوبها، ولكنها لا تسمح
بحلِّ المشاكل الحالية.
فالتقليد يجعل فقهاء الإسلام يجمعون على إباحة كل ما ليس هناك نص واضح صريح
بتحريمه، لذا على كل جيل أن يبذل الجهد في تفسير النصوص، كما يدعونا إلى
ذلك القرآن في كل صفحة من صفحاته، وهذا يسمح بحل المشاكل التي تعترضنا وفق
العقلية التي أوحت إلى الرسول طريقة الحكم في دولة المدينة، وفي الإسلام
إمكانات وتطلّعات أكبر من ذلك، حتى في ذلك الزمن الذي بلغ فيه ذروته،
ونظراً لإفلاس النموذجين الأمريكي والسوفيتي، يمكن للإسلام إفساح مجال
الأمل لعالم اليوم، إذا قضينا على فكرة سدِّ باب الاجتهاد الذي حكم به خلال
أجيال، فقضى على الإسلام بالتراجع، وإذا أدخلنا المبادىء المنشطة التي
تبرز عظمة الإسلام أولاً من ناحية "الإيجابية"، بحيث تخضع الناس والأعمال
لقانون يهتم بالنتائج وبالمعنى.
حتميـة الحـل الإسلامي
أما بالنسبة للتكنوقراطيين، فإننا نجدهم دائماً يتساءلون كيف؟ ولا نجدهم يسألون مطلقاً لماذا؟.
ونودّ أن نذكر بأن الاختصاص لمجرد الاختصاص، والعلم لمجرد العلم، والفن
لمجرد الفن، هو نسيان مميت للهدف، بإحلال الوسائل بدلاً من النتائج، ويبقى
طلب المعنى لهذه الأعمال والهدف منها هو الذي يقودنا إلى ذكر الله.
وبالنسبة "للفردية" التي تجعل من الفرد محور كل شيء، فيمكن استبدالها بالشعور "بالجماعة"، أي بعالم مركزه في غيره.
وإذا نظرنا إلى "الحتمية" التي تقود إلى عواقب مميتة وإلى عدم الكفاية التي
تهدد الإنسان في مستقبله باعتباره امتداداً لماضيه وحاضره، فيمكننا
مواجهتها، وتحطيم الطوق من حول الإنسان، وفتح مستقبله بشكل غير محدود،
بتأكيدنا على القوة العلوية الإلهية التي تنتشلنا من نمو كمي عددي أصبح
وثناً يعبد، وإلهاً مزوراً يسجد له من دون الله، وأعتقد أن هذا أصبح
بالنسبة لمسلمي الغرب أمراً ضرورياً، فالإسلام هو تتويج للسلالة
الإبراهيمية والذي يدعو الإنسان إلى أن يفتش ويبحث عن نهايته العظمى،
ومآله، كما يمكن للإسلام أن يعيد إحياء الأمل في مجتمعاتنا الغربية
المتأثرة بالفردية، بطريقة من النمو تقود العالم بأجمعه إلى الانتحار،
ولكننا لن نحقق هذا الأمل بشكل كامل إلا إذا وعينا دائماً ما كتبه (فوريس)،
بأننا لن نكون أوفياء للأجداد بالمحافظة على رفاتهم، ولكن بنقل الشعلة
التي أوقدوها.
انا لست بداعيه او شيخ انما انا عبد من عباد الله اريدها دوله اسلاميه .....

